
تنبيهُ الإنسان لمعنى الانطواءِ العربيِّ للأسرةِ في البوادي والبلدان
لم يعرف للعربِ التعصبُ ” للأسرةِ” أو “الفصيلةِ” لمجرّد تحقيقِ المصطلحِ، أو التسميةِ، وإنما لمعنى الأسرة؛ ذلك الجامعُ الكبير المنطوي على تحقيقٍ ثقافي يبرز “العشيرة” في محيطها ومن ثمّ في غيرهِ من الاصقاع والديار إذ تمتدُ الأسرةُ عن طريقِ الخبرِ والشعرِ السمة الأكثر ظهورًا لِتسفرَ عن “المكون الاجتماعي” وبهذه الصورة يكون للمرويةِ أثرًا بارزًا في تشكيلِ القيمةِ المعنويةِ للفردِ وللجماعةِ التي ينتمي إليها، ولا يكون للاسم والمصطلح أي دورٍ إلا في تعزيز الارتباط ومد الأواصرِ بين أفرادها؛ لذا تقرأُ في المروياتِ والقصائدِ العشيرةَ كوصفٍ دلالي بارز يشارُ إليه ليضيءَ منطقةً يشترك فيها جماعة، ويصدق عليهم ما يصدق على المجموع ومن ذَلك التواترُ المشهور لقصتيّ بني أنف الناقة، وبني نمير، إِذ نجد أن العشيرتان وبمختلفِ الأحوالِ لم يحملوا طابع التقديّس للمسمى، وإنما للجماعةِ فالمسمى لا يملكُ قيمةً أكبر من الدلالةِ على الأرومةِ والعشيرة، وبذلك اتجه الجميع إلى التخفيفِ من حِدة “المرويَّة الهجائيَّة” بالبعدِ عن التسميةِ، فبعد أنْ هجى جريرٌ نميرًا صار الواحد منهم يبعدُ بنسبتهِ عن نمير إلى جَدٍ آخر، ببساطة، لم يكن لنمير أي صفةٍ مَزيدة وإنما المنعةُ والقوة للعشيرةِ فبعد أن كان الرجل من نميرٍ يفخمُ في نطقهِ لاسمه خيلاءً صار يذكرُ من اجدادهِ غيرَ “نمير ” بعد البيت الشهير “فغض الطرفَ إنكَ من نميرٍ…” وكذا الحالُ في بني أنف الناقةِ الذين كانوا لا يخبرون بهذهِ النسبة المحققة حتى جاء الشاعر الحطيئة وقال: ” قوم هم الأنف والأذناب غيرهم.. ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا” فعاد بنو أنف الناقة إلى الافتخارِ بالعشيرةِ من خلالِ مدلول الاسم، لا تعصبًا له، وإنما لما يحمل البيت من مدلولٍ للعشيرةِ المشهورة، فلم تكن الشهرة بقطٍ محصورةً تحت اسمٍ أو منتسبٍ إليه، وإنما إلى “الأرومةِ” مهما كانت، إذ يصدقُ عليها بعمومٍ ما يصدقُ على أدنى أفرادها المنتسبين لها؛ لِذا نجدُ أن السؤددَ والرِفعةَ لا تكونُ إلا بالانطواءِ تحت المنظومةِ العربيةِ الثقافيةِ، فتحصلُ الأسرة على المكانة المشهودة، والمنزلة المعلومة، عِندَ العربِ، فبذلك وبتحورِ أسماء العشائر الكبيرة دليل قوي على الارتكاز على المعنوي أكثر من الاسمي المحدود (عشيرة العناقر كأنموذج تميمي فريد). إنّ ربط التاريخ بمجردِ المسمى غير معروفٍ عند العرب، وكذا في نجدٍ إذ تشكلُ أعمق دلالةٍ على عدم اعتبارِ التسمية وإنما المعنى وهو “الأسرة” أو العشيرة ذات الأفرع والامتداد، وبذلك يتجلى لنا عمق ما هو عربي أن العرب تعرفُ اتصالاتها بذويها، وتقدر ذلك، وتجعل له أعز المكانة والتوقير، وفي السنةِ يظهر جليًا عبرَ بعض المعاني الوافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ” ابن خالةِ القومِ منهم ” ” أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب ” “الأئمة من قريش ” “إن الله اصطفى قريشًا ” وغير ذلك من الأدلة منها تحملِ العاقلة الدية ، فليست العشيرةُ مناطةً بما يحقق التسمية وإنما بتحقيقِ النسبةِ وهو الانطواء بالنسبِ بالأدلة العربية والشرعية إلى المعنى الجامع في الأرومةِ وهو ” العشيــرة” لذا استحبَ اتحادهم تحت اسمٍ لا لأن للاسم خصيصة وإنما لإشارته للاجتماع والصلة، فالتعصبُ للاسماءِ لم يعرف عِند العربِ لأنّ العربي قد يناصرُ من عشيرتهِ وسواها الأباعد دون الأقارب لهذا المعنى، وقد نصرَ النبي صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج وهما عشيرةٌ ليست من بني عدنان، وكان في تأخي المهاجرين والأنصار عظيم الدلالة على عظم ما دعى له الإسلام من الألفة والمودة والتقوى، وليسَ التعصب خلف المسميات أو حتى الفصائل والفخر الأجوف الذي لن ينتج لحامله إلا “الثبور” .
إن العرب ولعمق تكوينهم الاجتماعي الممتد عمقًا في الثقافة عززو بنزولِ القرآن الكريم الذي أرسى عِمادًا راسخة لِما حسنَ من ثقافتهم، ومحى وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما فسدَ مِنها، فبقي لنا هذا المعيّن صافيًا لنستقي مِنهُ الدلالةَ ونمتثل لذلك نجد في تكوينهم الاجتماعي عِدة أمورٍ :
الإقرار بفضلِ القريّب والبعيد، وإنْ كان خصمًا، بينما نقرأُ أحيانًا عند من لا يفقه تحميل الخلاف الشخصي اسقاطًا نسبيًا للأثبات عند من لا يفقه الثقافة ولا العروبة والإسلام .
اعتماد العربي على التأزر بين افراد العشيرة لتحقيقِ معنى التناصرِ بالحق، واعانة الضعيفِ التي لا تقصرُ على النصح وإنما تقديم المساعدة المالية، والنفسية، والاجتماعية من ذلك يظهر أثر صفة الحلم والأناة على الثقافة العربية، وظهورها القوي عند الأحنف وهي خلّة حميدة مرغوبة.
الاعتماد الدلالي على المفهوم العميق للاستخدام اللغوي لمعنى “العشيرة” و “الفصيلة” و “العِترة” وغير ذلك من المفاهيم التي تعزز الاتصال العميق بوصل المسمى دلالة على الاجتماع والاتصال الخيِّر لا الفخر الأجوف الذي يرتكز على ذكرِ الأمجاد دون البناءِ في الحاضر لمستقبل الأسرة وأبنائها وانطوائها تحت وطنٍ كبير ذا ثقافةٍ راسخة عظيمة.
عدم اتخاذ الأدلة التي توصم بالعلمية وهي ليست كذلك ومن صورهِ اعتبار للوثائقِ دون العرفِ الاجتماعي وهو “الكفاءة ” عند أهل نجد مثلاً وهو الوصف الذي يسمى حاملهُ نسيبًا، أو اعتبار نقولات من هب ودب كمرويِّةٍ تاريخية يعول عليها دون اتباعٍ حقيق لمنهجية التتبع، والقراءة للارث التاريخي المنقول والمحكي ومن ذلك استخدام النقود العلمية على الوثائق بمحض اختلافِ مذهبِ قارئ الوثيقة عن القاضي الذي دون حكمه عليها، فيقول مثلاً شهادة الفرع عند الحنابلة كذا، وعندنا نحن المالكية كذا فنرد الوثيقة وقد تم حكم الحاكم، وتملك أجيال على أجيال تبعًا له، ومن ذلك التحكم بأن الخطأ في اللغة خطأ في الخبر وهو مما لا يعول عليه فالمجالُ اللغوي يختلف عن المجال النقلي المبسوط في كتبِ مصطلح الحديث، ومن ذلك الادعاءات العامة لمجتمعٍ ما كادعاء (أن كل أهل نجد انتقلوا منها في الماضي، وما بقي منهم أصيِّل ينسبُ إلى عشائرها) فهذا وما سبق يحتاج إلى مزيدِ تحققٍ وتواترٍ وتدوين في مصادر شتى لأنه لن يخفى على العرب ورود جائحة عامة ببلد كذا او كذا، فإن لم تذكر وتشتهر فإن تتطرق للاحتمال ولا مجال له في الأمور العامة. والقارئ لكتب الفقه يرى أن النسب يثبت بأدنى الأدلة، وأن ادعاء الأغلب بالتواتر للتحقق غير سليم، وإنما يتطرق الشك للجميع إذا تم اعمال الشك فيهم لأجلِ الشك خصوصًا على الأسر النسيبة الأصيلة، وأغلب العرب تعرف انسابهم واحسابهم وفقًا لهذا التواتر للاعتبار الاجتماعي، ومن ثمّ النظر فيما دونه من الأدلةِ، والعربُ أمة لا تنفي الأنساب اعتباطًا وانما هي متشوفة للإثبات ويرتكز ذلك لديهم في اعتمادِ الحلف، فتجد الكثير من أبناء القبائل منطوين تحت قبائل أخرى بالحلفِ ولاعتبار الفِعال في النفس والمال وليس الكلام فقط.
إن عدم قيام أفراد العشيرة أو الأسرة بتعزيز هذا وغيره مما اعتبره العرب يدل على التفتت والضعف وربما الانعدام، وليس لقبيلةٍ عربية متحضرة أم بدوية أي خصيصة على أخرى في نظامها الاجتماعي، ومشيختها القبلية، فهذهِ قريش سيدها أبو سفيان، وهذه تميم وأسيادها قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهؤلاءِ غيرهم، فليس لقبيلةٍ أن تقول أن لي خصيصة في نظامي الاجتماعي وترتبيتي، وإنما العشيرة تعرفُ عند العرب بمحددها في القرآن الكريم وبفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وليسَ بالتخرص أو النظر خارج نطاق الدلالة، و لأنّ الانتساب للأسرة عند العرب منطوٍ على معانٍ راسخة، وليسَ للمسمى، الذي طمرهُ أهل نجدٍ باعتبار الكفاءةِ دلالةً أولى وأقوى. نعرف بذلك أن لكل مجتمع نظامه الاجتماعي فعندا تكون هناك معانٍ عميقة لا يمكن لنا أن نعمل تحكيم دلالة (الحمض النووي مثلاً) وإن كان يستأنس بهِ فكيف بهِ عن المنطوين بالحلفِ؟ او الاعتبار؟ أو سائر الأدلة الشرعية التي اعتبرها الفقهاء.
إن “الأســـرة” ممتدة، متصلة، عميقة، بمعين ثقافي معضد بالقرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وفعل العرب واشعارهم، ومستقياتهم المصقولة عبر الامتداد العميق، فعلما إذًا نأخذُ ثقافةً دخيلة علينا ولدينا من الجود والحسن المزيد؟
يشاهد على المجتمعات التي لم يعرف عنها الرسوخ ” الأمريكي ” كمثالٍ خلاق، العودة لاتباع التأزر من خلال الأخويات وهي اجتماع مجموعاتٍ بشرية في مكانٍ يكون سكنى لهم في المدينة ويحوي عدة مرافع حيوية من بقالات للأغذية وخلافه، ومحلات للملابس ، وغير ذلك مما يسهم في دعم اقتصادي للمجموعة لأنها صنعت بالاشتراك، وتحسين معيشي، ودعم ثقافي، وهي فكرة عربية خالصة تدل على تقدم العرب الثقافي منذ القدم .
والسلام عليكم .
هيثم بن محمد البَرغش، آل ريـــّس
الرياض 41/08/04هجري .

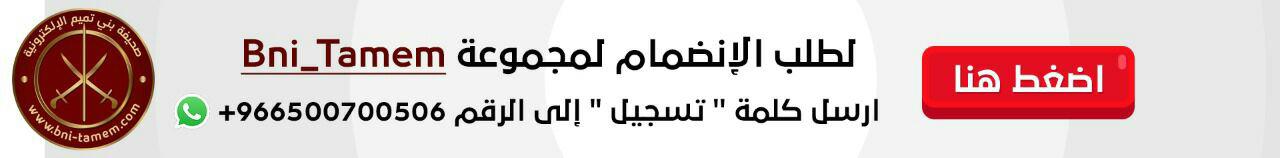

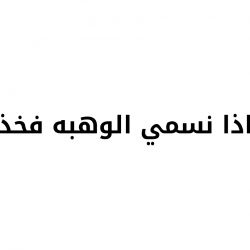


3 comments
3 pings
ابراهيم الخليفه
31/03/2020 at 10:21 م[3] Link to this comment
بارك الله فيك مقال رائع ونتطلع لمقالات اخرى
Ra
08/04/2020 at 7:24 م[3] Link to this comment
رائع جداً كعادتك ياهيثم
التميمي
11/04/2020 at 7:59 م[3] Link to this comment
مقال جميل ورائع 👍